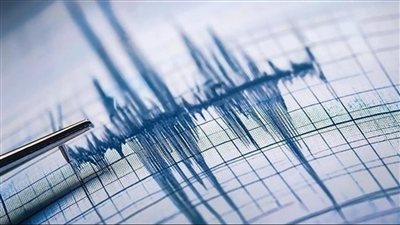هل تدفع إسرائيل لبنان نحو "تفاوض قسري" على قواعد الاشتباك؟

مع اقتراب مرور عام كامل على وقف إطلاق النار الذي لم تُكتب له الحياة يومًا، بل انتهى فعليًا لحظة توقيعه، يجد لبنان نفسه أمام تحوّل نوعي في السلوك الإسرائيلي جنوبًا. فالاتفاق الذي أنهى الحرب الدامية العام الماضي تحوّل منذ ساعته الأولى إلى صيغة نظرية، نتيجة "بدعة" ما سُمّي بـ"حرية الحركة" التي منحتها تل أبيب لنفسها، مستندة إلى تفسيرها الخاص والنسبي لـ"تهديد أمنها"، بل حتى وجودها.
وإذا كانت إسرائيل ارتكبت على أساس هذا التفسير، سلسلة متواصلة من الغارات والقصف والاستهدافات داخل القرى الجنوبية من دون أن يردعها أحد، بما في ذلك الدول التي صُنّفت "ضامنة" للاتفاق، فإنّ "حزب الله" بقي في المقابل ملتزمًا بالاتفاق وبآلية "الميكانيزم" التي تُدار عبرها خروق القرار 1701، داعيًا المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل من أجل إلزامها بتطبيقه من جهتها.
وعلى امتداد الأشهر الماضية، ظلّ هذا المشهد ثابتًا: حرب من طرف واحد، تُنفّذها إسرائيل تحت سقف هدنة شكلية، في ظل صمت دولي وتحصين سياسي داخلي متآكل. ومع نهاية العام، تقف البلاد عمليًا أمام منعطف جديد: جدار إسمنتي يتخطّى الخط الأزرق للمرة الأولى بهذا الوضوح، بشهادة قوات اليونيفيل، التي تحدّثت صراحة عن قضم آلاف الأمتار من الأراضي اللبنانية، قبل أن تتعرّض هذه القوات للاستهداف الإسرائيلي المباشر.
وإذا كان الحديث عن حرب غير متكافئة، بدأ عمليًا منذ لحظة توقيع الاتفاق، وربما قبله، فإنّ التطورات الأخيرة حملت إشارات إلى مرحلة مختلفة؛ إذ انتقلت إسرائيل من نمط "الخروق الروتينية" إلى خطوات محسوبة تُراد لها أن تقلب المعادلة، في مشهد يضع لبنان أمام سؤال أكبر بكثير من "الخروقات"، ويتعلّق بما إذا كانت تل أبيب تدفع نحو "إعادة تفاوض قسرية" على قواعد الاشتباك، من دون إطلاق رصاصة واحدة من الطرف الآخر.
عندما بدأت أعمال بناء الجدار قرب بلدة يارون، كانت الإشارات الأولية توحي بأنه تحصين عسكري عادي، حتى بدا كأنها جزء من الإجراءات التي اعتادت تل أبيب اللجوء إليها بذريعة حماية المستوطنين. لكن ما انتهت إليه الوقائع غيّر المعادلات، إذ إنّ الجدار تجاوز الخط الأزرق، وقضم جزءًا من الأراضي اللبنانية، وهو ما وثّقته قوات اليونيفيل نفسها التي أكدت أن إسرائيل تعمل خارج الإطار القانوني المرسوم منذ عام 2000.
ورغم اعتراض لبنان الرسمي، لم تُظهر إسرائيل أي استعداد للتراجع، بل استكملت البناء في نقاط أخرى. بهذا المعنى، لا يمكن التعامل مع الجدار بوصفه تفصيلاً هندسيًا أو تحصينًا عابرًا، بل يكاد يكون إعلانًا صريحًا بأن تل أبيب تصوغ حدودًا جديدة بتمريرٍ تدريجي، خصوصًا أنه يأتي في ظل حديث إسرائيلي متزايد عن ضرورة "تحجيم حزب الله"، وعن خيارات مفتوحة قد تمتد نحو إيران أيضًا في المرحلة الأخرى.
وهكذا، تُدخِل إسرائيل الجدار كعنصر تفاوضي جديد مع لبنان، ليس على مستوى الحدود فقط، بل على مستوى قواعد الانتشار في الجنوب، وحركة الجيش اللبناني، ومهام اليونيفيل، وتعريف "الأمن" نفسه. وفي كل الأحوال، يمكن لتل أبيب ادعاء ربح جولة إضافية، فإما تقضم الأرض وتحولها إلى منطقة عازلة بحكم الأمر الواقع، أو تفرض على لبنان الدخول في مسار تفاوضي غير مباشر تحت ضغط الوقائع الميدانية.
لا تقف الأمور عند هذا الحدّ، فبالتزامن مع أعمال تشييد الجدار، جاء الاستهداف المباشر لقوات اليونيفيل ليكشف جانبًا آخر من التحوّل في سلوك تل أبيب، إذ كان يمكن لإسرائيل أن تبرّر إطلاق النار على دورية اليونيفيل بأنه "خطأ" أو "سوء تقدير"، لكنها لم تفعل، في وقت قالت القوة الدولية إنّ الدورية بقيت مُحاصَرة لأكثر من نصف ساعة، وهو ما لا يترك مجالاً للشكّ بأنّه استهداف مباشر لقوات من المفترض أنها الضامن الأول لتطبيق القرار 1701.
بهذه الضربة، تتعامل إسرائيل للمرة الأولى مع اليونيفيل كطرف مزعج، لا كقوة وظيفتها التهدئة، أو ربما كجهة تسعى تل أبيب لمحاصرتها لا التنسيق معها. ولعلّ الرسالة الواضحة خلف ذلك هي أنّ الحركة الدولية نفسها باتت تحت النار، وبذلك، يصبح استهدافها جزءًا من مسار أكبر يهدف إلى تفريغ القرار 1701 من محتواه، وإلى دفع القوة الدولية نحو مربع جديد تُفرض فيه على عناصرها قيودٌ غير معلنة، قد تعيق دورها الرقابي المفترض.
يحدث كل ذلك في وقت لا يسجَّل فيه أيّ نشاط عسكري لـ"حزب الله" جنوب الليطاني، وذلك تحت عنوان الالتزام بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، على الرغم من أنّ الغارات الإسرائيلية لم تتوقف يومًا واحدًا. وهنا المفارقة التي لا يمكن القفز فوقها، فإسرائيل لا تردّ على عمل عسكري بادر إليه الحزب، بل تضرب في فراغ عسكري، وهو ما يجعل الحرب الحالية حربًا لتغيير البيئة، لا حربًا لاحتواء خطر.
وهكذا، يصبح الهدف الإسرائيلي غير مرتبط بحسابات الردع، بل بإعادة هندسة البيئة الجنوبية نفسها، وضرب المعادلة التي قامت عليها الهدنة منذ 2006، والتي جعلت من القرار 1701 إطارًا مشروطًا بوجود قوة أممية وجيش لبناني وانتشار مضبوط لحزب الله. وفي غياب الفعل العسكري المقابل، تتحول الخروق الإسرائيلية إلى جولات أحادية متراكمة، تتيح لها إعادة رسم الحدود وتعديل التوازنات على الأرض من دون حرب.
في مقابل ذلك، يلجأ لبنان الرسمي إلى المسار الدبلوماسي الذي يبدو، حتى اللحظة، المسار الوحيد الممكن. فقد رفعت وزارة الخارجية شكوى جديدة إلى مجلس الأمن، طلبت بموجبها تدخّلًا دوليًا لوقف الانتهاكات وإلزام إسرائيل بالانسحاب من النقاط المحتلّة. لكن هذا المسار، رغم ضرورته، يفتقر إلى أدوات الضغط، وهو ما يجعل أثره محدودًا في مواجهة احتلال موضعي يثبت وجوده يومًا بعد يوم، وهو ما تؤكّده التجربة الطويلة مع الخروق الإسرائيلية، التي أثبتت أن مجلس الأمن يُسجّل الانتهاكات ولا يوقفها، ويستنكرها ولا يردعها.
وفي وقت برزت محاولة رئيس مجلس النواب نبيه بري رفع منسوب الخطاب الوطني، عبر دعوته القوى السياسية إلى الوحدة في مواجهة "الانتهاكات والمخططات"، يبدو أنّ هذه الدعوة تصطدم بواقع الانقسام اللبناني العميق حول كل مفصل من مفاصل الملف الجنوبي، من دور المقاومة إلى مستقبل 1701، مرورًا بترتيبات الأمن على الحدود، وحتى النظرة العامة إلى إسرائيل وخطرها.
في ظل هذا الانقسام، يبقى لبنان الرسمي في موقع المتفرج القَلِق أكثر منه موقع الفاعل القادر، فهل تقوده إسرائيل عمليًا إلى "قواعد اشتباك" جديدة، ولو من دون حرب؟.
حتى الآن يبدو المشهد ملتبسًا بين التهويل الإسرائيلي المتصاعد بإمكانية شنّ حرب جديدة على لبنان، وبين تحليلات كثيرة تشير إلى أنّ تل أبيب تفضّل في هذه المرحلة استمرار "حرب الاستنزاف" على خوض مواجهة واسعة. ثمّة من يرى أنّ ما تسعى إليه إسرائيل عمليًا ليس تمهيدًا لحرب شاملة، بل تأسيس لوقائع ما قبل الحرب، إن صحّ التعبير، من خلال فرض حدود جديدة، ومعايير جديدة للاعتراض، بالتوازي مع تعديل مهام اليونيفيل واستنزاف البنية الاجتماعية في الجنوب تحت سقف تهدئة شكلية.
في ظلّ هذه المقاربة، تتحوّل كل خطوة إسرائيلية إلى استثمار سياسي-أمني بعيد المدى، يمنحها عناصر تفوّق إضافية قبل أي مواجهة مستقبلية محتملة، في وقت ليس سرًا أنّ لبنان لا يملك ترف إعادة التفاوض، ولا ترف الحرب، ولا ترف الصمت. ومع استمرار إسرائيل في مسارها الأحادي، يصبح السؤال الحقيقي: إلى أي حدّ تستطيع هذه الحرب الصامتة أن تستمر من دون أن تنفجر حدودها؟ وهل نحن أمام تعديل تدريجي لقواعد اللعبة قبل الحرب، أم أمام تثبيت نهائي لوقائع جديدة سيجد لبنان نفسه مضطرًا للتعامل معها كأمر واقع على المدى الطويل؟.